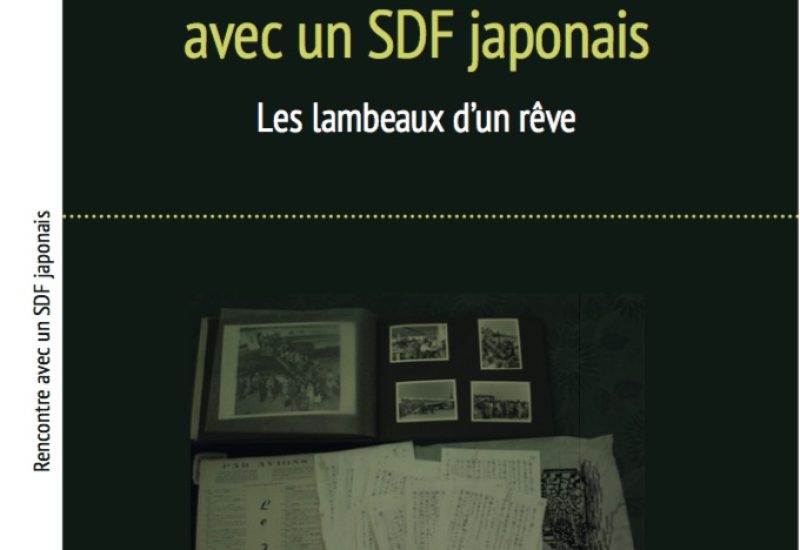ها هو سياق الربيع العربي يلتقي بالذكرى الـ٣٨ لحرب أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٧٣ أو حرب الغفران، كما يسميها الإسرائيليون. في أيامنا هذه اختفت ثلاثة من معالم هذه المعركة الكبرى بين العرب وإسرئيل: التفوق النوعي الاسرائيلي اندحر بعد حربي تموز ٢٠٠٦ والحرب على غزة، كما أن «أحد أبطالها على الجبهة الغربية» حسني مبارك يقبع وراء قضبان السجن، بينما النظام الذي ورث «ثاني أبطالها على الجبهة الشرقية»، حافظ الأسد، يتضعضع ويتقوقع على نفسه نتيجة رياح ربيع الثورات العربية.
لم تخرج حتى اليوم وثائق «ويكيليكسية» أو ما شابه لتفيدنا بحقيقة أن الهجوم العربي لم يكن «هجوماً مفاجئاً ومباغتاً على إسرائيل». بالطبع إن بعض الظن إثم، إلا أن الوقائع التاريخية والنتائج التي ترتبت على هذه الحرب، تشير إلى أن وراء أكمة التحضير لهذه الحرب نوع من «البازار التفاوضي» تفوح منه رائحة سيء الذكر هنري كيسنجر ويقضي بتحريك الخطوط وصولاً إلى تغيرات جيوسياسية واستراتيجية حاسمة، يشتم منها رائحة تحضير للانتقال من جبهة الصمود إلى جبهة المسالمة كحل لمسألة الشرق الأوسط بشكل جذري.
قوام هذا الحل في تفكير كيسنجر بني على ما يبدو على أسس تفكير استشراقي فوقي يرى في العرب «ذكوراً فخورين تم إذلالهم عبر حرب ٦٧»، ومن هنا جاءت فكرة «الحرب المحدودة» التي لا تفني الغنم (لا تحرر كل الأرض المحتلة) ولا تقتل الناطور (هزيمة أخرى للعرب)، تسمح للجميع بحفظ ماء الوجه والالتفات إلى سلمٍ يفاوض عليه الاسرائيلي، من موقع قوة بالفعل، يجبر أقوى دولتي مواجهة، هما في الواقع في موقع ضعف بالفعل، على القبول بالشروط بحجة أن إنهاء التفوق الإسرائيلي هو هدف النضال.
إلا أن الأمور سارت بعكس ما تشتهي رياح استراتيجية كيسنجر: فأنور السادات كان «يخبئ» أهدافاً أقل بكثير من مرامي كيسنجر، ولربما الإسرائيليين أنفسهم. طموحه الوحيد كان «الفرعنة» والانتقال إلى تحت السقوف الذهبية في العواصم الغربية، كان يحلم بتدخين الغليون وارتداء لباس «جنتلمان فارمر» ولعب دور خديوي لدى الغرب، وحشر مصر العربية داخل حدود مصرية ضيقة لجعلها مزرعة له ولمحيطه من رجال الأعمال. لذا فهو ما أن توغلت قواته نحو عشرين كيلومتراً في سيناء حتى أوقف القتال ونحر جيشه الثالث المغلوب على أمره برفض التحرك لسد ثغة الدفرسوار والقضاء على جيش شارون، الذي كان رويداً رويداً يتقدم نحو القاهرة. في أي دولة وفي أي زمن كان هذا الكاكم سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى. إلا أنه لم يكف حتى اغتياله عن الاحتفال بحرب أكتوبر.
من جهتهم، تغاضى الاسرائيليون عما يمكن أن يكون قد خطط له كيسنجر، فهم يعرفون أن صراعهم مع العرب هو صراع بين حضارات لا مجال فيها للتكتيكات ولا للاستراتيجيات، إذ إن خسارة معركة واحدة هي كارثة لهم لأن هدفهم هو «كسر العرب»، كسر أي بارقة أمل في إمكانية اللحاق بركب المساواة، بل يجب «إفهام العرب عبر هزيمة جديدة ضرورة طأطأة الرأس». لذا فما أن تم تثبيت الجبهة المصرية على بعد بضعة كيلومترات من خط السويس المقفل منذ ٦٧ حتى نقل الجيش الاسرائيلي كافة قواه نحو الشرق، ليرد القوات السورية على أعقابها وينقض على طلائع الجيش العراقي الذي كانت تتحرك عبر الأردن للمشاركة في المعركة. لم يتوقف الجيش الإسرائيلي إلا بعد أن وضع بينه وبين عاصمة الأمويين ١٠٠ كيلومتر فقط، كما هو الحال بينه وبين عاصمة الفاطميين ١٠١ كيلومتر. لم يبح كيسنجر بكلمة واحدة، لا بل دعم انتقال الطيارين الأميركيين من الطائفة اليهودية لـ«ممارسة واجبهم الوطني» في «الدفاع عن الوطن القومي»، رغم أن اندفاع اسرائيل يخالف توجهات السياسة العليا الأميركية و«المتفق عليه». لو يقرأ اليوم الرئيس الأميركي باراك حسين أوباما هذا المقطع من التاريخ لأدرك أن إسرائيل ومؤيديها لا يهتمون إلا بما يهم إسرائيل. وقصف باخرة التجسس الأميركية «ليبرتي» من قبل القوات الإسرائيلية خير دليل.
أما على الجبهة الشرقية، فإن الأسد، الذي كان ينتظر من هذه الحرب عودة الجولان وتقاسم دمشق زعامة العالم العربي مع القاهرة، فقد رأى جيوشه تتراجع عن النقاط البسيطة التي تقدمت إليها، وهي تجر الهزيمة وراءها وجيش الدولة العبرية بات على مشارف عاصمته، عندها فهم أن السادات تلاعب به وتركه يحرق جيشه ويفقد مصداقية التحرير.
إلا أن لدى الزعماء في جعبهم ألف حيلة وحيلة لـ«الانتصار على واقع الحال»، فالأسد استفاد من خيانة السادات الظاهرة ليبرر خسارته وتموضعه في جبهة الرفض، بينما السادات استفاد من جبهة الرفض هذه ليبرر «استبدال العرب بسيناء». الأسد أقفل أبواب سوريا بمزلاج الرفض أولاً قبل أن يستبدله بقفلِ الممانعة، بينما السادات فتح أبواب مصر لتنهش الليبرالية من ثرواتها، وقطع الجسور بين «أم الدنيا» والعالم العربي، وجال بين حدائق قصور الغرب يتلقى الجوائز بلباس «غباردين إنكليزي»، بينما شعبه الذي انتظر ثمرات اتفاقية السلام يئن تحت ضير وحشية الاقتصاد الحر ويتفرج على السواح والإسرائيليين يتجولون بين أهرامات الجيزة وشرم الشيخ بحراسة رجال الأمن المصريين بلابسهم الأسود الشهير. وصدَّقت بعض الدول نظرية «القزم فوق الشجرة» وإمكانية العيش من دون مصر وتكملة النضال. لم يغير وصول حسني مبارك شيئاً، فهو محى من الذاكرة الجماعية «خيانة السادات» بجعل ذكرى حرب أكتوبر «تبجيلاً لدوره» في قيادة الطيران الحربي، وظن نفسه فرعوناً أكثر من فرعون، فلم يعين نائباً للرئيس خوفاً من الخيانة. إلا أن واقع شعب مصر لم يتغير. فكان فقر الأكثرية يتسابق مع ثروات الأقلية، فيما التطرف يلعب دور الحكم ويشجع الفريقين المتسابقين في اتجاهين مختلفين.
في سوريا، تابع النظام التنديد بالخيانة المصرية ودعا إلى ترك الهموم «اليومية القُطْرية» الضيقة والإلتفات إلى «الهموم القومية» العليا، وفي مقدمتها لبنان الذي دخله الجيش المهزوم في الجولان ليدعم سلماً أهلياً في ظل حرب دامت عشرين سنة، تخللتها معركة حمص الأولى في الداخل وخسارة ٨٦ طائرة في معركة جوية واحدة فوق العرقوب، إلى جانب فاصل «عدم مواجهة احتلال لبنان» بتبريرات جمة منها «المحافظة على الجيش العربي السوري»، بينما مبارك لم يحرك ساكنا أمام غزوة لبنان وترك الفلسطينيين يذبحون مثل النعاج في صبرا وشاتيلا وينتقلون بالبواخر الفرنسية إلى أبعد نقطة عن فلسطين في العالم العربي: اليمن.
أما إسرائيل، فما جنته من حرب أكتوبر الكوميدية هو أضعاف أضعاف ما كان يحلم به كيسنجر؛ ومن دون توسع، يكفي تعداد المعارك التي حققت فيها انتصارات لم تكن تحلم بها قبل «حرب الغفران»، رغم هزيمة ٦٧: توقيع اتفاقية مع مصر وسحبها من الصراع، سحب خطوط الغاز والنفط المصري حتى تل أبيب، وصول السفير الإسرائيلي لينعم بمياه النيل، وجحافل من السواح نصفهم جواسيس ورجال أعمال يحيكون شوارع مصر شرقاً وغرباً، اختفاء اللاءات الثلاث (لا صلح لا اعتراف لا تفاوض) بابتعاد مصر عن الصراع، احتلال شريط في جنوب لبنان (١٩٧٨)، قصف مفاعل تموز في العراق (١٩٨١)، واحتلال جنوب لبنان وصولاً إلى بيروت العاصمة (١٩٨٢)، ثم طرد ياسر عرفات (١٩٨٣) وبعد ذلك أمكن توقيع معاهدة وادي عربة (١٩٩٤) التي سحبت الأردن من الصراع «لتريح إسرائيل»، التي التفتت إلى لبنان لتقوم بعدد من المجازر عبر الحدود اللبنانية وداخل أراضي بلاد الأرز أشهرها عملية عناقيد العنب (١٩٩٦) التي ذهبت دمرت المنشاءات ونكلت بالأطفال. ناهيك عما حصل من «تطور» (إذ أمكن القول) للمستعمرات في الضفة الغربية التي لم تبقى على تواصل يتجاوز ١٨ كيلومتراً متواصلة وباتت الضفة الغربية مثل «جبنة الغويير» السويسرية المليئة بالثقوب، إلا أن الفلسطينين يفاوضون لأن حرب أكتوبر نجحت في «تطعيم الفكر العربي» بطعم المفاوضة. على ماذا يفاوضون؟ يفاوضون للمفاوضة ويعطون «ما حصل في سيناء وطابا» كجواب… علينا الاكتفاء به. مع ذلك تتواصل عمليات القضم معتمدة على أن «رغبة التفاوض» على أراضي ما وراء حائط الفصل التي يقضمها المستعمرون الإسرائيليون يوميا فيما العالم يتفرج ويعود للتفاوض.
رغم كل هذا لم تتوقف الاحتفالات سنوياً بـ«حرب أكتوبر»، مضحك هذا اللاوعي الجماعي عند الحكام ومبكي جدا تفاعل الجماهير بهذه الاستعراضات.
هل تكون الاحتفالات هذه السنة مثل السنوات السابقة؟ من صعب جداً. إذ أن شخصنة الانتصار لم تعد ممكنة لمبارك المسجون ولم تعد موجودة للهالة التي كانت تحيط بالأسد بعد سقوط كل تماثيله في سوريا. أما «حجة تبجيل الانتصار بقهر الإسرائيلي» فقد زالت بحربي لبنان وغزة التي أظهرت «بحق هذه المرة» أن تكلفة ربح إسرائيل لأي حرب مقبلة باتت مكلفة جدا.
واقع اليوم الذي يزين ذكرى حرب أكتوبر يتمثل بعاملين أساسيين متواجدين في ساحة الصراع العربي الإسرائيلي: احتلال إسرائيل للأرض ونزول الشعوب العربية إلى الساحات لإزاحة من كان يدعوهم للتصفيق لهزيمة واعتبارها انتصاراً. الشعوب العربية مدعوة للانتباه للاحتفالات (حتى لاحتفالات الثورة والربيع العربي) فالحاكم الذي يدعو لاحتفال يخبئ شيئاً ما وراء أكمته. المطلوب من الشعوب العربية الاعتراف بخسائر وتفعيل ما يسمى بـ«التغذية الراجحة» أي الاستفادة من أخطاء الماضي وإصلاح ما يمكن إصلاحه ورمي جانباً ما لا يصلح والتفتيش عن الجديد، للانطلاق إلى الأمام.
المسألة الفلسطينية هي «لب الصراع العربي الإسرائيلي» ولب «الواقع العربي المؤسف» ولب «أسس غياب نهضة عربية»، وهي بنفس الوقت محرك قوي جداً. مهما قال المعلقون على الربيع العربي (الذين يفقهون لغة الضاد أو لا يجيدونها) من تونس ومصر والبحرين واليمن وصولاً إلى دمشق، فإن المسألة الفلسطينية كانت وما زالت موجودة وحاضرة في لاشعور هؤلاء الثوار الذين ييريدون إزاحة الأصنام. هذه الأصنام التي عربدت واستبدت ونهبت وقتلت وشنعت وحبست البلاد بحجة «انتظار حل مسألة فلسطين».
مسألة فلسطين سوف تجد حلاً عند هؤلاء الذين سوف يبنون مجتمعاً جديداً مبنياً على الصراحة والعلم، إن الأرض لن تذهب إلى المريخ، فلا تقولوا «كفاية» التفكير بفلسطين و«بدنا نعيش»… لقد حاول السادات ومبارك قبلكم تلقيم «كفاية وبدنا نعيش» للشعب، إلا أن شعب مصر قلب سحر «كفاية» على السحرة وهكذا تفعل وستفعل بقية الشعوب التي تقول كفاية كذب وتدجيل ونريد العيش أحراراً لتحرير فلسطين.