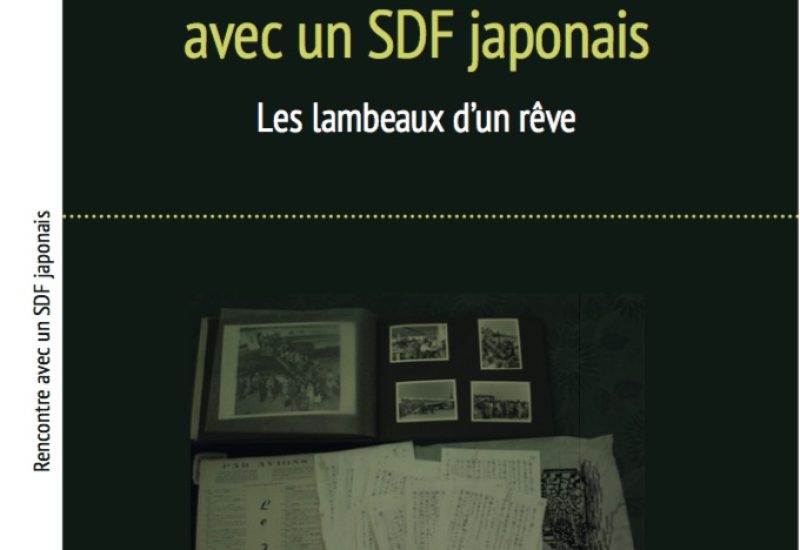هرع جاري يطرق الباب ويطلب مني أن ألاقيه في المقهى المقابل للبناء الذي نسكن فيه. في هذا المقهى عدد من الزملاء الذين يلتقون بعد ساعات العمل. هذا اليوم كانوا ثلاثة وأنا رابع من أصول عربية، ناهيك عن أصحاب المقهى الجزائريين، وجارنا من الفرنسيين «الأقحاح» ولكن المنفتح على العرب والراغب بصحبتهم ومعاشرتهم والنافر من اليمين الذي يدب رويداً رويداً في عروق أوروبا.
كان ينظر لنا شذراً ويتفحص في وجوهنا كما لو أننا ارتكبنا عملاً فظيعاً. نظرة تذكر بنظرات كثيرين بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في ٩/١١ فانتظرنا أن يرشف القهوة قبل أن يتنفس عميقاً ويروي ما حصل له.
قال: “بعد عودة ولدي وابنتي من المدرسة غابا لدقائق معدودة في غرفتهما وهرعا إلي يسألاني «بابا هل صحيح ما فعلوا مع القذافي؟»، أجبت «نعم أعدموه إنه ديكتاتور». نظرا إلى بعضهما البعض وبعد تردد قال الصبي «ولكنهم فعلوا أكثر من ذلك» ومن دون تفكير سألت «ماذا فعلوا؟» احمرت وجنتا الطفلين وقالت البنت «لا نستطيع لفظ هذا…عيب». فجأة قفز إلى ذهني ما تناهى لي عبر شبكات التواصل الاجتماعي من روايات مشينة بعضها لا يصدق وأكثرها صعب التصديق، فصرخت بهما «من كلمكما عن هذا الشيء». بكل برودة أجابني الطفلان «بابا هذا على فايسبوك». نهضت لفوري وفطعت فايسبوك الأولاد، رغم يقيني أن الأمر لن يدوم وأنهما لا بد أن يشاهدا ما يتجاوز ذلك بأبعاد خفية عني وراء الستار الرقمي”.
نظرنا إلى بعضنا البعض نحن العرب، رغم استياء مشترك مما حصل ولطخ وجه الثورة الليبية والربيع العربي، إلا أن كنا نتبادل النظرات لمعرفة مقدار مسؤوليتنا ونحن في باريس على شاطئ السين مشمئزين مما يحصل ومن تفويت فرصة محاكمة ديكتاتور. وكأن الجار فهم معنى ارتباكنا، فأراد إفراغ كامل جعبته، فرشف قليلاً من القهوة، وقال: «أنتم العرب لقد شوهتم ثورتكم لا تستطيعون القيام بأي عمل جماعي من دون حرفه عن مساره». تنفس قليلاً وتابع لاهثاً وهو يهم أن ينهض «يلزمكم جنود أميركيون» ثم توجه نحو الباب. سألته قبل أن يدلف من الباب «لماذا أميركيون؟» ابتسم وتمتم بصوت تناهى لنا همساً «صدام».
بالفعل صدام ديكتاتور، مثله مثل القذافي، يصعب الدفاع عنه وعن حكمه الذي أنهك بلاده بحروب ونزاعات واشترى عصي ليضربه الغرب بها ويحتل بلاده ويخربها. صدام مثله مثل القذافي ظهر مرة أو مرتين قبل السقوط يتباهى في حي شعبي يهتف له قلة من الخائفين. الاثنان هربا واختفيا في حفرة قبل القبض عليهما.
الفارق الوحيد أن صدام «أمسكه الأميركيون وحافظوا عليه وحموه». سمحت هذه الحماية للنظام العراقي الجديد، أياً كانت التحفظات، أن يقول أجرينا محاكمة للديكتاتور. محاكمة، أيا كانت الانتقادات، ولكنها سمحت لصدام بحمل القرآن وقراءة الرسائل ونهر القاضي والكلام والتصدي والشتيمة. وأخيراً حكم عليه، وأيا كانت الاعتراضات على الحكم، فهو حكم قضائي قد يكون في ظل احتلال بغيض، إلا أن هذا الاحتلال حافظ على قشور براقة لعملية قضائية. وسلم المحتل الأميركي صدام ليلة تنفيذ الحكم، الذي شابته فوضى. إلا أن الديكتاتور صعد إلى منصة المشنقة أمام قاضي ومدعي عام ومحام وعدد لا يستهان به ممن لم يكن وجودهم ضرورياً.
أما الدكتاتور الآخر الذي حرصت قوات الناتو على مطاردته من الأجواء وكان لها دور كبير، إن لم يكن الأكبر، في القبض عليه فقد وقع في قبضة شعبه. بالطبع لا نستطيع أن نتصور ما يشعر به من فقد غالياً في هذه الحرب أو في فترة الحكم المتسلط لـ ٤٢ سنة، إلا أن هؤلاء الثوار قضوا بـ«فعلتهم هذه» على نقاء ثورتهم.
ما ذنبنا نحن الجالسون في مقهى على ضفاف السين؟
ذنبنا أننا عرب أو من أصول عربية. فالاستشراق الذي وصفه إداور سعيد قابع في لاشعور الغرب، يرصد كل ما يصدر عن أي عربي. أن يشتري أمير عربي فرساً بملايين الدولارت يكون نصيبنا بعض الهزء. أن تمنع النساء من قيادة السيارات في بلاد لم تطأها أقدامنا، فإن التهكم يكون من نصيبنا حتى ولو كانت زوجاتنا يقدن سيارات سباق. أن يلطخ الثوار نقاء ثورتهم أو أن تصادر ثلة عسكرية ثورة، فالنظرات المتأسفة توجه لنا أينما كنا وأيا كانت آراءنا السياسية.
ما فعله ثوار ليبيا، أيا كانت الظروف، مشين بحقنا لأننا صفقنا لسقوط الديكتاتور، لأننا نبهنا الغرب مراراً من هؤلاء الديكتاتوريين فلم ينصت لنا حين كان يتجار معهم. نحن رحبنا بالربيع العربي وها هو يتحول إلى خريف عار.
بانتظار إعلان سيطرة المتطرفين على مقدرات ليبيا وإرساء نظام ثيوقراطي بدأت تباشيره تظهر، ما زال فايسبوك أولاد الجيران مقطوعاً عن أخبار العرب.